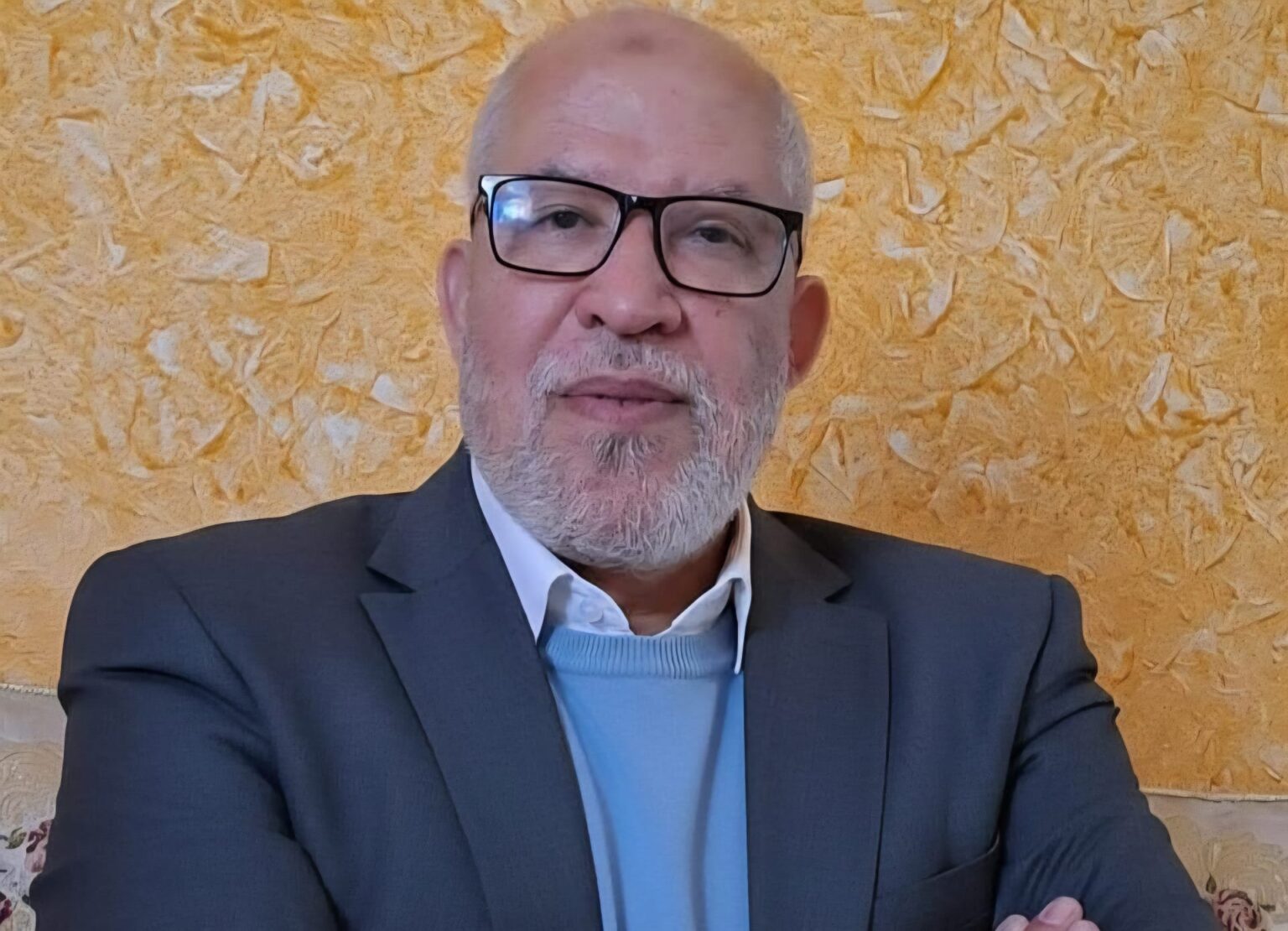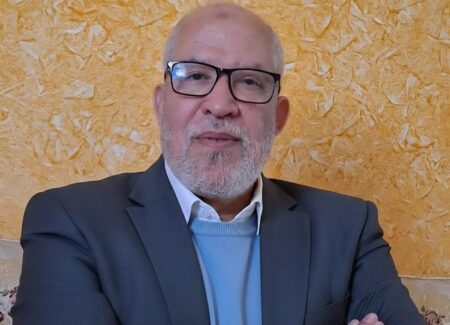بقلم: عبدالفتاح الحيداوي
حين أنشأت الدولة المركز المكلف بملف معتقلي ما يُعرف بـ”السلفية الجهادية”، سرعان ما طُرح السؤال حول موقع هذه المبادرة: هل هي امتداد لمسار “الإنصاف والمصالحة”، الذي فُتح لمعالجة انتهاكات الماضي السياسي، أم أنها مجرد مبادرة ظرفية تنحصر على تدبير ملف محدد زمنياً ومرحلياً؟
الخلفية التاريخية هنا بالغة الأهمية. فالمغرب سبق وأن خاض تجربة رائدة في العالم العربي من خلال “هيئة الإنصاف والمصالحة”، التي ارتبطت بسياق العدالة الانتقالية، وسعت للاعتراف الرسمي بضحايا سنوات الرصاص. هذا المسار منح الدولة نوعاً من الإصلاح، كما منح الضحايا مساحة من الاعتراف وجبر الضرر في ظل محدودية استجابته لكل المطالب.
غير أن هذه التجربة تركت أثراً سياسياً وأخلاقياً في معالجة ملفات لاحقة، ومنها ملف المعتقلين السلفيين، المحكومة بالمقارنة والتساؤل حول استلهامها من منطق الإنصاف.
المغزى يتجاوز الجانب الإجرائي. فإذا اعتبر المركز نفسه امتداداً لسياسة الإنصاف والمصالحة، فإن ذلك يضفي على معتقلي السلفية صفة “الملف السياسي”، أي أنهم ليسوا مجرد متهمين في قضايا أمنية، بل ضحايا سياق سياسي وأمني اتسم بالارتباك والخلط بين الفكر والممارسة، بين التدين والاتهام بالإرهاب.
هذا الاعتراف يعني أيضاً فتح الباب أمام مطالب جبر الضرر، سواء عبر مراجعة المحاكمات أو في صيغٍ من التقارير الحقوقية، أو عبر إعادة إدماج هؤلاء المعتقلين في إطار العدالة الانتقالية بخصائصها الحقوقية والسياسية.
أما إذا قُدم المركز باعتباره مجرد مبادرة ظرفية، ذات بعد أمني أو فكري، فإن ذلك يعكس رؤية ضيقة تختزل الملف في كونه “مشكلة تقنية” تخص مجموعة محدودة، تستوجب التدبير المرحلي، دون أفق أوسع مما تستدعيه الاعترافات التاريخية.
بهذا المعنى، يصبح المركز أداة لإدارة أزمة آنية، لا لبناء ذاكرة حقوقية أو تصحيح مسارات سياسية، النتيجة هنا هي غياب البعد الحقوقي والسياسي في الملف، والاكتفاء بخانة “الاستثناء” الذي لا يقاس على تجارب العدالة الانتقالية السابقة.
الأولوية النقدية تكمن في الخيار الذي يتبناه المركز.
فإذا أُعلن امتداده لمسار الإنصاف والمصالحة، فإن الدولة تكون قد وسّعت أفق العدالة الانتقالية ليشمل فئة جديدة من المعتقلين، مما يفرض التزامات دقيقة تتعلق بالاعتراف والمراجعة، وربما إعادة الاعتبار.
أما إذا انحصر في كونه مبادرة ظرفية، فإن الدولة تعرّف بدراسة مفادها أن ملف السلفية الجهادية ليس سوى قضية أمنية، منقطعة الصلة عن ماضي الانتهاكات وبالتالي لا مجال لربطه بمنطق الإنصاف والمصالحة المجتمعة.
وبين هذا الخيار وذاك، يظل السؤال مفتوحاً حول طبيعة رؤية الدولة لمستقبل المصالحة: ما هي رؤية شاملة تدمج كل ضحايا السياقات السياسية والأمنية، أم أنها رؤية انتقائية تُجزِّئ الملفات وتبقي بعضها في دائرة “المبادرات الظرفية”؟
المركز بين سؤال العدالة وإعادة التأهيل
من أبرز الإشكالات التي تطرح على المركز المخصص لمعتقلي السلفية الجهادية هي كيفية التعامل مع فئة من المعتقلين ما زالت تؤكد براءتها أو تشتكي من محاكمات افتقدت لشروط العدالة.
فالكثير من هذه الملفات تعود إلى مرحلة ما بعد أحداث 16 ماي 2003 حيث صدرت شهادات متواترة عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب وغياب الضمانات القضائية الأساسية، وهو ما جعل تقارير حقوقية دولية ووطنية تتحدث عن محاكمات غير منصفة.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل يعتبر المركز نفسه معنيا بمراجعة هذا الإرث القضائي، أم أنه يتجاوزه ليتركز فقط على جانب “إعادة التأهيل الفكري”؟ إن الاقتصار على إعادة إدماج اجتماعي سلوكي دون ضمانة تسليم بشرعية تلك الأحكام الصادرة، يعني تلك الأحكام ستبقى حجر عثرة في الجدل الحقوقي في المقابل، إذا أبدى المركز استعدادا للتعامل بمرونة مع هذه الفئة – سواء عبر آليات الوساطة أو عبر الاعتراف بوجود مظالم سابقة – فإن ذلك سيكون بداية إقرار غير مباشر بأن العدالة لم تتحقق في كل الملفات.
هذه النقطة تمثل مأزقاً حقيقياً: تجاهل المظلومية القضائية يعني إغلاق الباب أمام أي نقاش جدي في العدالة الانتقالية الخاصة بملفات ما بعد 2003، بينما الاعتراف بها قد يفتح على الدولة واجب المراجعة والمساءلة. من هنا يمكن القول إن مركز المصالحة يقف على تقاطع حساس بين منطق “إعادة التأهيل” ومنطق “الإنصاف”، وهو ما يجعل طريقة تعاطيه مع هذه الفئة من المعتقلين اختباراً لمصداقيته، ليس فقط أمام المعنيين مباشرة، بل أمام الرأي العام الحقوقي والسياسي برمته.
فعالية برنامج المراجعات: بين الوعود والانتقائية
أحد أبرز الإشكالات التي تثير الجدل حول برامج “المراجعات” الموجهة لمعتقلي السلفية الجهادية هو مصير أولئك الذين انخرطوا في المسار الإصلاحي، خضعوا لجلسات الحوار والتكوين، وأعلنوا استعدادهم لمراجعة قناعاتهم السابقة، لكنهم لم يخرجوا بأي مكاسب ملموسة: لا عفو، ولا تخفيف العقوبة، ولا حتى إدماج اجتماعي بعد الإفراج.
هذا الواقع يطرح سؤالاً محورياً: إلى أي حد يمكن اعتبار البرنامج أداة إصلاح حقيقية، وليس مجرد آلية زمنية أو انتقائية؟
الخلفية الحقوقية والسياسية لهذا السؤال تكشف أن الدولة حين أطلقت هذه المبادرات، قدمتها باعتبارها جسراً نحو التوبة والمصالحة، وبدلاً من منطق العقاب الصرف.
غير أن غياب نتائج ملموسة لدى فئة واسعة من المعتقلين، ممن استوفوا شروط الانخراط في البرنامج، يبوح بوجود فجوة بين الخطاب والواقع. هذه الفجوة تهدد مصداقية التجربة، بل تفتح الباب أمام تأويلات سلبية ترى في البرنامج مجرد وسيلة “لاختبار الولاء” وقياس درجة الانصياع، أكثر مما هو مدخل لإعادة التأهيل والاندماج.
من زاوية علم الاجتماع السياسي، تتحول مثل هذه المبادرات إلى أداة مزدوجة، فهي من جهة تكشف الدولة عن إظهار حسن نيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي عبر خطاب المصالحة، ومن جهة أخرى تضع أفراد المعتقلين وتصنيفهم وفق معايير قد لا تكون معلنة، مثل درجة الثقة وقابلية التحكم.
لكن حين يغيب الأثر الملموس في حياة الأفراد، يصبح البرنامج فاقداً لجوهره الإصلاحي ويتحول إلى تجربة شكلية قد تعمق شعور المعتقلين بالغبن، بدل أن تفتح لهم آفاقاً جديدة.
إذا لم يترجم الانخراط في البرنامج إلى نتائج واقعية، فإن الغاية المعلنة (الإصلاح والمصالحة) تفقد مصداقيتها، ويغدو البرنامج أقرب إلى محك أمني أو اختبار سياسي. وهذا ما يهدد بتحويله من أداة “جبر ضرر” إلى أداة “إعادة إنتاج الإقصاء”، بما يكشف فقدان الثقة في مبادرة مستقبلية.
الازدواجية في تصنيف معتقلي السلفية الجهادية: بين “سجناء رأي” و”مجردي حق عام”
من أبرز الإشكالات التي تميزها التجربة المغربية في التعامل مع معتقلي السلفية الجهادية هي طبيعة التصنيف القانوني والسياسي لهؤلاء المعتقلين.
فإذا كان المركز الرسمي المحدث لمتابعة أوضاعهم يقوم ببرامج مراجعة فكرية وحوارات تأهيلية، فإن ذلك يوحي بشكل واضح أن القضية في جوهرها فكرية – أي مرتبطة بمعتقدات وقناعات وتأويلات دينية – وليست مجرد خرق للقانون الجنائي بالمعنى التقليدي.
هذا المنحى يقترب من معاملة المعتقلين كـ”سجناء رأي”، لأن الحوارات الفكرية والبرامج التأهيلية لا تكون عادة موجهة للمجرمين العاديين، بل لأولئك الذين يحملون أفكاراً تحتاج – في نظر الدولة – إلى المراجعة أو التصحيح.
لكن في المقابل، وبمجرد خروج هؤلاء المعتقلين من السجن، لا يعاملون معاملة سجناء الرأي أو المعتقلين السياسيين، بل يتم التعامل معهم كأشخاص سبق لهم أن ارتكبوا جرائم جنائية، مما يُبقي على وصمة “المجرم” ملتصقة بهم اجتماعياً وقانونياً. لا يحصلون على رد اعتبار، ولا يُنظر إلى ماضيهم باعتباره جزءاً من سياق سياسي أو حقوقي استثنائي، بل يُدرجون ضمن خانة “الحق العام”.
هذا التناقض يكشف ازدواجية في التصنيف الرسمي:
فإذا اعتبرنا أن هؤلاء معتقلون فكريون أو سجناء رأي، فهذا يقتضي الاعتراف بأن محاكماتهم لم تكن عادية بالضرورة، ويستتبع منطقياً فتح ملف الإنصاف والمصالحة معهم، إذ لم يُعوَّضوا ورد الاعتبار لهم، تماماً كما حصل مع ضحايا الانتهاكات السابقة في “سنوات الرصاص”.
أما إذا تم التعامل معهم كمجرمين عاديين، فإن مقاربة “النقاش الفكري” أو “إعادة التأهيل” تفقد معناها، إذ لا حاجة لإقناع اللص أو مهرب المخدرات بمراجعة أفكاره، بل يكفي تطبيق العقوبة.
بهذا المعنى، نحن أمام سياسة مزدوجة الخطاب:
- خطاب إصلاحي/تأهيلي يقدَّم للخارج وللرأي العام لإظهار أن الدولة تتبنى مقاربة ناعمة، إنسانية، تعتمد الحوار بدل القمع.
- واقع عملي/قانوني يمارس على الأرض ويصنّف المعتقلين كأصحاب سوابق جنائية، دون أن يمنحهم أي وضعية حقوقية استثنائية.
هذا الازدواج في التعاطي يطرح أسئلة عميقة: هل الغاية من البرامج التأهيلية هي إدماج فعلي للمعتقلين، أم فقط تحسين صورة الدولة دولياً في مجال محاربة التطرف؟ وهل يمكن أن نعتبر هؤلاء “سجناء سياسيين” بالمعنى الحقوقي، أم أن تصنيفهم كمجرمين يظل أداة لتفادي فتح ملفات سياسية حساسة تتعلق بالمحاكمات والسياق الأمني لما بعد 2003؟
إن الإجابة عن هذه الإشكالات تتطلب نقاشاً جريئاً حول طبيعة الاعتقال نفسه، وحول حدود “العدالة الجنائية” في مواجهة ما هو في عمقه قضية فكرية وسياسية.
فاستمرار هذا التناقض لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمعتقلين، وبين الخطاب الرسمي والواقع العملي، مما يجعل أي “مصالحة” ناقصة ومهددة بالانهيار، بدل أن تكون أول اختبار.