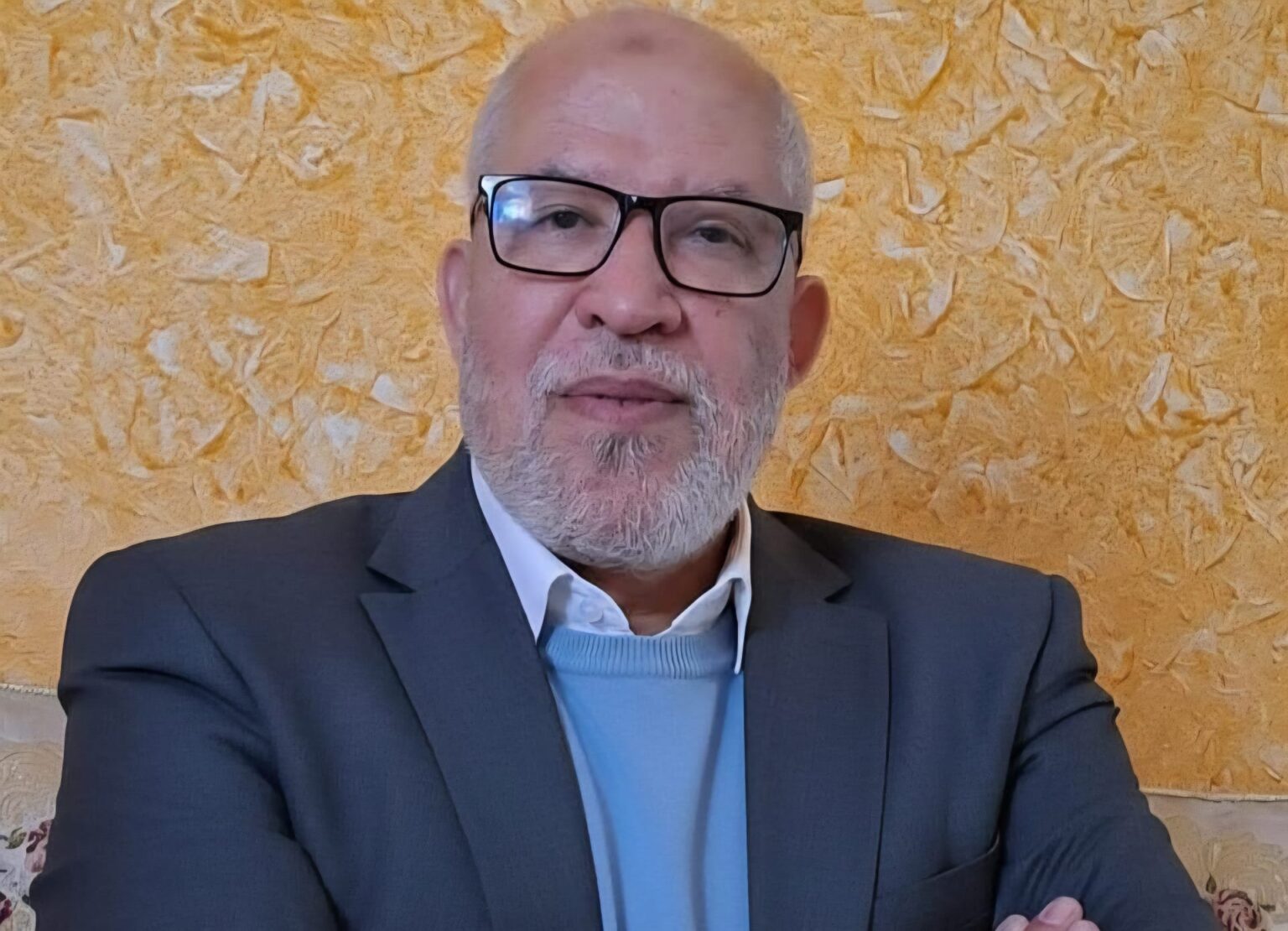بقلم: عبد الفتاح الحيداوي
مقدمة: أزمة الذاكرة وضرورة التوثيق
تعد الذاكرة الحقوقية لأي مجتمع جزءًا أصيلًا من وعيه بذاته وتاريخه، وفي سياقات التحول السياسي والاجتماعي، تبرز أهمية حفظ هذه الذاكرة، لا سيما تلك المتعلقة بفئة المعتقلين السياسيين أو الحقوقيين. إن المشروع المقترح تحت عنوان “مشروع الذاكرة الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين”، من التوثيق إلى السردية، ينطلق من إدراك عميق لأزمة مجتمعية لهذه الذاكرة، سواء بفعل التهميش الرسمي، أو الرقابة، أو ضعف المبادرات الذاتية للتوثيق.
إن غياب التوثيق المنظم يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد التاريخ القريب، بما فيه من تفاصيل التجربة الفردية والجماعية، ومآلات النظام، ومراحل التحول الفكري التي مر بها هؤلاء الأفراد.
وعليه، فإن الهدف الأسمى لهذا المشروع يتجاوز مجرد رواية الألم إلى تحويل المعاناة إلى معرفة، والشهادة إلى ذاكرة تحفظ الكرامة وتوجه المستقبل.
أولًا: الفلسفة والأهداف الاستراتيجية
يقوم المشروع على قناعة مفادها أن حفظ الذاكرة الحقوقية للمعتقلين هو جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية الشاملة، وتتركز أهدافه الاستراتيجية في محاور أساسية:
- التاريخ والتوثيق: توثيق المسار الزمني لكل معتقل بدقة، بدءًا من تاريخ الاعتقال مرورًا بظروف الاحتجاز والتنقل بين السجون، وصولًا إلى نوع المعاملة التي تلقاها.
- إعادة الاعتبار: العمل على إعادة الاعتبار الإنساني والفكري للمعتقلين، ومواجهة سنوات التشويه الإعلامي التي لحقت بظالمهم، وتقديمهم كأفراد مرّوا بتجارب معقدة.
- بحث الأكاديميين: إنشاء أرشيف بحثي مفتوح وموثوق يكون مرجعًا للباحثين والحقوقيين والصحفيين، مما يسهم في إنتاج معرفة بديلة وموضوعية.
- التحصين ضد التحريف: تحصين التجربة من النسيان أو التحريف عبر وسائط رقمية ومؤسسات مدنية مستقلة، لضمان استمرارية الرواية الحقيقية.
ثانيًا: الهيكلة التنظيمية المقترحة
لتحقيق هذه الأهداف، يقترح المشروع هيكلة تنظيمية تقوم على أربع لجان متكاملة:
يهدف هذا المشروع إلى بناء سردية حقوقية موثقة وشاملة حول واقع السلفيين وتجاربهم داخل المؤسسات السجنية وخارجها، من خلال منظومة متكاملة من اللجان المتخصصة، تتولى:
لجنة التوثيق الميداني:
جمع المعطيات والشهادات المباشرة باعتماد استمارات موحدة تراعي الأبعاد القانونية والإنسانية والصحية، مرفقة بالوثائق والأحكام والصور والرسائل.
وتعمل لجنة الأرشيف والذاكرة على تحويل هذه المادة الخام إلى قاعدة بيانات رقمية مهيكلة، تُصنّف فيها الملفات حسب السجون والتواريخ والقضايا، وفِقَها للاستعمال الأكاديمي والإعلامي.
أما لجنة الرصد الإعلامي والتوثيق الفكري، فتعكف على متابعة الخطاب الرسمي والإعلامي المتعلق بملف السلفي قصد إعداد أرشيف تحليلي يقارن بين الصورة الإعلامية المتداولة والصورة الواقعية المستخلصة من الشهادات الميدانية.
وتتكامل جهود هذه اللجان مع لجنة النشر والتواصل التي تتولى مهمة نشر السردية الحقوقية عبر منصة إلكترونية متخصصة، وترجمة المواد الأساسية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى إصدار نشرات دورية وأوراق بحثية تبرز التحولات الفكرية والحقوقية ذات الصلة.
يطمح المشروع في مجمله إلى ترسيخ مقاربة علمية وحقوقية قادرة على إعادة التوازن إلى الخطاب العام حول السلفيين، وإتاحة مادة توثيقية صُمّمت تساهم في بناء فهم موضوعي بعيد عن الأحكام المسبقة والتوظيف السياسي والإعلامي.
من الناحية التقنية، يشدد المشروع على ضرورة بناء منصة رقمية موحدة باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر، مع مراعاة مبادئ الأمان الرقمي والخصوصية.
ويجب أن تحتوي هذه المنصة على قاعدة بيانات للمعتقلين، ومكتبة وثائقية، وأرشيف إعلامي، وقسم للشهادات الصوتية والمرئية.
ثالثًا: التصور التحليلي: من الذاكرة الفردية إلى العدالة الانتقالية
إن القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تكمن في آلياته التنظيمية فحسب، بل في إعادة المعرفة والإنسانية العميقة التي تشكّل “التصور” المطلوب.
- تفكيك الصورة النمطية وإنتاج المعرفة البديلة
يقدم المشروع فرصة فريدة لإنتاج معرفة بديلة تفكك الصورة النمطية السائدة عن “المعتقل السلفي” أو “المعتقل السياسي” عمومًا.
فبدلًا من السردية الرسمية أو الإعلامية التي غالبًا ما تركز على الجوانب الأمنية أو الإيديولوجية، تبرز الشهادات الموثقة التطور الإنساني والفكري للمعتقلين، وتسليط الضوء على تفاصيل حياتهم اليومية، ومعاناتهم، وتحولاتهم الفكرية داخل السجن.
هذا التحول في السردية ضروري لصياغة حوار مجتمعي أكثر نضجًا وموضوعية حول هذه الفئة.
- تأصيل ثقافة التوثيق الذاتي
تأصيل ثقافة التوثيق الذاتي
تأصيل ثقافة التوثيق الذاتي داخل التيارات الإسلامية يمثل تحولًا عميقًا في الوعي الجمعي لهذه التيارات، التي طالما اعتمدت على الذاكرة الشفوية في حفظ تاريخها وتجاربها.
غير أن الاعتماد المفرط على الرواية غير الموثقة جعل الكثير من الأحداث والوقائع عرضة للنسيان أو التشويه، سواء بفعل الزمن أو بسبب التوظيف الانتقائي من قبل خصومها أو حتى بعض المنتسبين إليها.
ومن ثمّ، فإن ترسيخ ثقافة التوثيق الذاتي لا يعدّ مجرد ممارسة تقنية أو أرشيفية، بل هو فعل معرفي وتاريخي يهدف إلى إعادة امتلاك الذاكرة من الداخل، وتحريرها من الهيمنة الخارجية التي طالما صاغت روايات بديلة عن الإسلاميين، غالبًا من منظور أمني أو إعلامي مناهض.
إن الانتقال من الشفوية إلى الكتابة المنهجية يمثل خطوة في اتجاه النضج المؤسّسي؛ إذ يتيح بناء ذاكرة جماعية دقيقة، تستند إلى شهادات موثقة ووثائق رسمية وسياقات تحليلية موضوعية.
وبهذا المعنى، يصبح التوثيق الذاتي أداة مزدوجة: فهو من جهة وسيلة لحفظ الذاكرة والتجارب السياسية والفكرية والاجتماعية، ومن جهة أخرى وسيلة للمراجعة والنقد الذاتي وتطوير الأداء التنظيمي والفكري.
فكل تجربة لا توثّق محكوم عليها بالتكرار أو الانقطاع، بينما التجربة الموثقة تتحول إلى رصيد معرفي قابل للتقييم والبناء عليه.
كما أن تأصيل هذه الثقافة يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحركات الإسلامية نفسها، من خلال نقل التجربة من مجال السرد البطولي إلى فضاء التحليل الموضوعي الذي يعترف بالنجاحات والإخفاقات على السواء.
فالتوثيق الذاتي هنا لا يعني تمجيد الذات أو تبرير الماضي، بل الانخراط في كتابة نقدية للتاريخ من داخل التجربة، بما يتيح استعادة التوازن بين الذاكرة الفردية والجماعية، وبين الحكاية الذاتية والقراءة المؤسّسة للتاريخ.
إن مشروع توثيق الذاكرة الإسلامية بهذا التصور لا يخدم فقط حفظ الحقوق وردّ الاعتبار، بل يسهم أيضًا في تأسيس مرجعية فكرية وتاريخية قادرة على مقاومة النسيان، وتقديم رواية ذات مصداقية للأجيال المقبلة، بعيدًا عن التزييف أو الانغلاق.
وبهذا، يتحول التوثيق الذاتي إلى ممارسة مقاومة بحد ذاتها، تُعيد الاعتبار للتجربة الإسلامية كفاعل تاريخي يمتلك وعيًا بذاته ومسؤولية تجاه ماضيه ومستقبله.
- الإسهام في العدالة الانتقالية
على المدى الطويل، يعدّ هذا الأرشيف الموثق رافدًا أساسيًا لجهود العدالة الانتقالية، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الانتهاكات التي تعرض لها الأفراد والجماعات في فترات مختلفة من التاريخ الوطني.
فعملية التوثيق المنهجية لا تقتصر على تسجيل الوقائع أو حفظ الشهادات، بل تمتد إلى بناء ذاكرة مؤسّساتية قادرة على تحديد أنماط الانتهاك، ورصد السياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها، وربطها بالمسؤوليات الفردية والجماعية والمؤسساتية على حد سواء.
ومن خلال هذا العمل، يتحول المشروع إلى أداة فاعلة في إرساء مقومات العدالة والمساءلة، لأنه يوفر الأداة الموضوعية الضرورية لكل عملية إنصاف أو مصالحة مستقبليّة، كما يسهم في تمكين الضحايا وذويهم من استعادة الاعتبار عبر الاعتراف الرسمي بمعاناتهم وتثبيت حقوقهم في الذاكرة الوطنية، وهو ما يُعدّ أحد الأركان الأساسية لأي مسار عدالة انتقالية ناجح.
إلى جانب ذلك، فإن توثيق التجارب الفردية والجماعية للظلم يمثّل خطوة جوهرية نحو ضمان عدم تكرار الانتهاكات، من خلال تحليل الأسباب البنيوية التي أنتجتها ومسائلة السياسات العمومية التي سمحت بوقوعها.
فالمشروع لا ينحصر في النظر إلى الماضي كحدث مغلق، بل يستشرف المستقبل بوصفه مجالًا لبناء دولة الحق والقانون القائمة على الاعتراف والمحاسبة، والإصلاح المؤسّساتي، وضمان الكرامة الإنسانية لكل المواطنين دون استثناء.
وبهذا المعنى، يصبح الأرشيف الموثق ليس مجرد سجل للذاكرة، بل ركيزة استراتيجية في التحول الديمقراطي، وأداة مرجعية للباحثين وصناع القرار والفاعلين الحقوقيين، تسهم في بلورة سياسات عادلة تضع الإنسان في صلب العدالة والإنصاف.
- ضمان الجِدّ والموضوعية كشرطٍ للقبول
يعدّ ضمان الجِدّ والموضوعية في عملية التوثيق الذاكرة الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع توثيقي يسعى إلى بناء مصداقية مجتمعية ومؤسسية مستدامة.
فالمشروع الذي يقدم نفسه بمنطقٍ أيديولوجيٍّ أو أداةٍ دعائيةٍ، يفقد تلقائيًا ثقة الجمهور، ويتحول من مبادرة توثيقية إلى ساحة صراعٍ رمزي بين الأطراف المختلفة.
ومن ثم، فإن تحييد الخطاب وتغليب المقاربة الحقوقية والإنسانية يشكلان الضمانة الحقيقية لقبول هذا المشروع في الحقل الأكاديمي والمؤسساتي، وتحويله إلى مرجع وطني مشترك للذاكرة الجماعية.
يشكّلان شرطين جوهريين لجعل المشروع مقبولًا لدى جميع الفاعلين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو السياسية.
إنّ جوهر الجِدّ لا يقتصر على تجنّب الانحياز في السرد، بل يتجسد أيضًا في آليات العمل وأساليب جمع المعطيات، بدءًا من تصميم الاستمارات الميدانية وصياغة الأسئلة، مرورًا بطريقة التعامل مع الشهادات والروايات المختلفة، وصولًا إلى منهجية التحليل والتصنيف.
فكلّ مرحلة من مراحل التوثيق يجب أن تُبنى على أسس مهنية شفافة تضمن التوازن بين الروايات وتمنع أي توظيفٍ انتقائي للوقائع.
كما أن الموضوعية تعني الضمان الأخلاقي والمعرفي لاستمرار المشروع في الزمن، فهي تمنح الضحايا وذويهم ثقةً بأنّ الغاية من التوثيق هي الاعتراف والإنصاف، لا الإدانة أو التبرير.
بذلك، يسهل الانفتاح على الذاكرة الجماعية دون خوف من التسييس أو التشويه.
ومن هنا، يتحول المشروع من مجرّد عملية جمع معطيات إلى فضاءٍ تفاعلي للعدالة الزمنية يسهم في ترميم الذاكرة الوطنية وبناء المصالحة المجتمعية.
لذلك، فإنّ الالتزام بالجِدّ والموضوعية لا يُعدّ خيارًا منهجيًا، بل هو الشرط الأخلاقي والمعرفي لشرعية المشروع وقبوله المجتمعي.
فبقدر ما ينجح المشروع في الحفاظ على مسافةٍ متساوية من جميع الأطراف، بقدر ما يتحوّل إلى مرجعٍ حقوقي وتاريخي موثوق قادرٍ على خدمة الباحثين، وصنّاع القرار، والضحايا، والمهتمين بتوثيق مسارات العدالة الانتقالية والذاكرة الوطنية على السواء.
خاتمة: واجب تاريخي ومسؤولية جيل
إن إنشاء مشروع الذاكرة الحقوقية ليس مجرّد ترفٍ فكري أو مبادرةٍ عابرة، بل هو واجبٌ تاريخي ومسؤولية جيل.
فكلّ تجربةٍ لم تُوثَّق تندثر، وكلّ ذاكرةٍ لم تُحفَظ تشوه.
يقع على عاتق الجيل الذي عاش المحنة مسؤوليةُ تأريخها بوعيٍ ومسؤولية، ليس فقط لمنع تكرارها، بل لتمهيد الطريق للأجيال القادمة دروسًا في الصبر والكرامة، وتحويل الألم إلى طاقة بناء ومعرفة.
هذا المشروع هو محاولة لترميم الذاكرة الوطنية، وتقديم سردية إنسانية عميقة تُعيد الاعتبار للضحايا وتضيء مسارات التحول الفكري والاجتماعي.