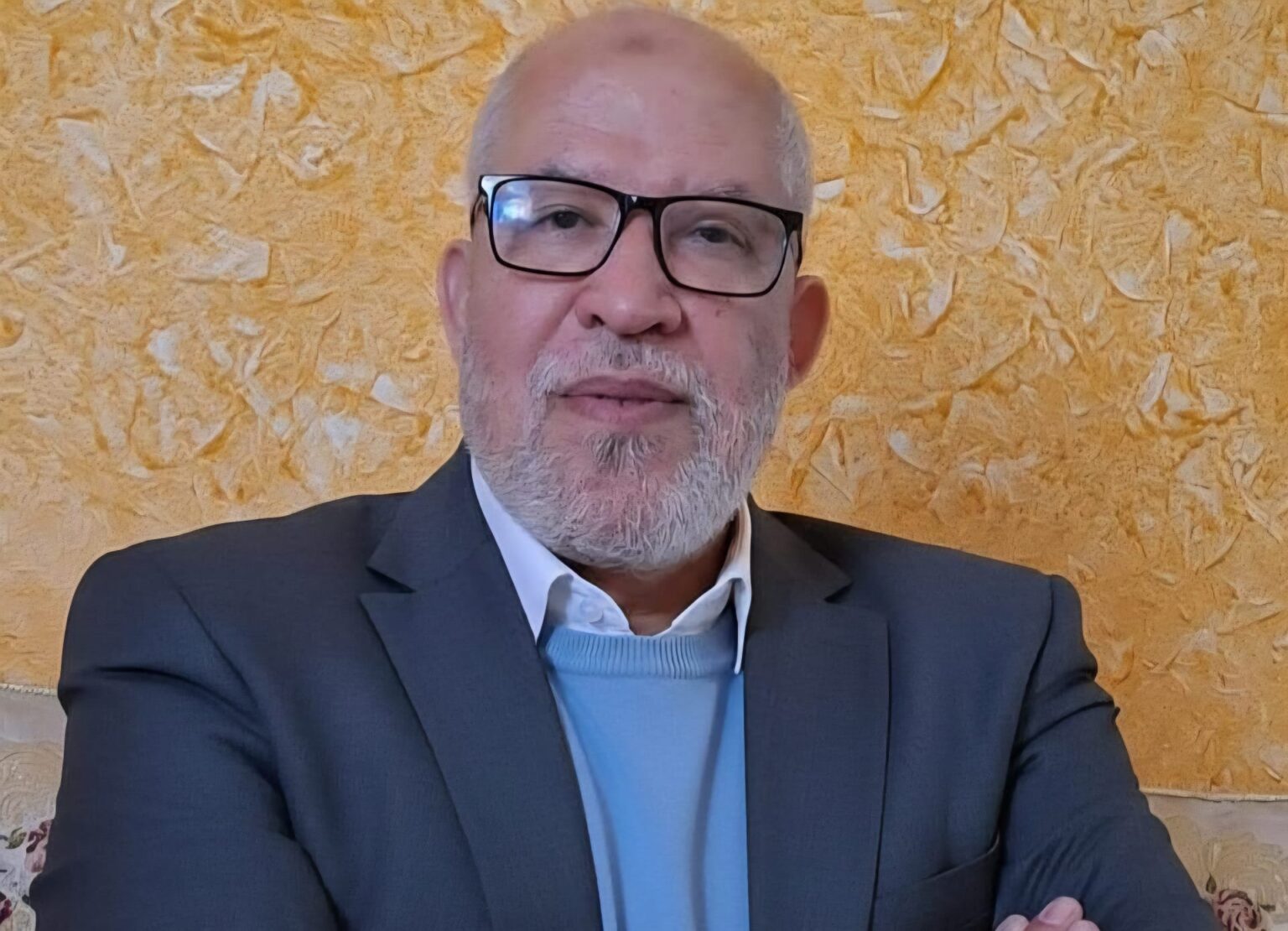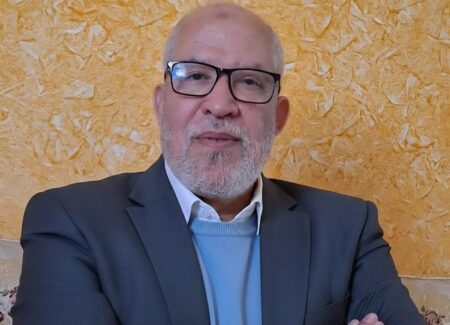بقلم: الحيداوي عبد الفتاح
تتناول هذه الدراسة أحد أهم الأحاديث النبوية المؤسسة لنهج التعامل مع القضايا السياسية والعسكرية في الإسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: «لا تُنزِّلوهم على حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله فيهم أم لا» (رواه مسلم).
تهدف الدراسة إلى استخلاص الدلالات الأصولية والسياسية لهذا التوجيه، وتوظيفها في نقد الخطابات المعاصرة التي تخلط بين الاجتهاد البشري والقطع الإلهي، وتحديدًا خطاب الحاكمية والتطرف، وتخليص الدرس الديني إلى الحد البشري؛ عبر ترسيخ مبدأ نسبية القرار السياسي، ونفي كل صفة العصمة أو القداسة، مما يجعل أساسًا نظريًا لتهذيب الفكر السياسي الإسلامي المعاصر.
- المقدمة: الإشكالية والأهمية
يمثل التراث النبوي مصدرًا لا غنى عنه لفهم المنهج الإسلامي في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ومن بين نصوص هذا التراث يبرز حديث بُريدة بن الحصيب في سياق محاصر، كنموذج لفهم العلاقة الساكنة بين النص الشرعي (الوحي) والسياسة العامة (الاجتهاد).
ويمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حكم الله» في مقابل «حكم المجتهد» إحدى مفاتيح فهم إشكالية الخلط بين المقدس والبشري.
هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة على السؤال الرئيس: كيف يضبط التوجيه النبوي في حديث «لا تُنزِّلوهم على حكم الله» العلاقة بين الوحي والسياسة؟ وما هي دلالاته النقدية للخطابات الحركية والجاهلية المعاصرة؟
- الإطار النظري: الحديث بين فقه السيرة والأصول
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيتهم، عن بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
وقد أجمع شُرّاح الحديث، كالإمام النووي، على أن النهي عن إنزالهم على حكم الله محمول على التنزيه والاحتياط، لأن الحكم الاجتهادي قد يقع في غير مراد الله تعالى، فيُنسب إليه، فيكون ذلك افتئاتًا على الشريعة.
التمييز بين “حكم الله” و”حكم المجتهد”
يمثل الحديث النبوي: «لا تُنزِّلوهم على حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم؛ فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله فيهم أم لا» مفتاحًا لفهم التمييز بين حكم الله بوصفه معصومًا، وبين الحكم البشري بوصفه اجتهادًا معرضًا للخطأ والصواب.
حقيقةٌ قطعيةٌ ثابتةٌ لا يدركها البشر إلا بنصّ صريح، وليس “حكم المجتهد” الذي لا يتجاوز كونه فهماً بشرياً محكوماً بشروط الواقع وحدود المعرفة.
هذا التمييز لم يكن مجرد قاعدة فقهية، بل شكّل أساساً لمنهج سياسي وأصولي عميق يُبعد المجال السياسي عن القداسة، ويجعله مجالاً للاجتهاد والتقدير والمصلحة… حتى في زمن النبوة نفسها.
يؤكد الحديث أن تنزيل حكم بشري على أنه “حكم الله” خطأٌ منهجي خطير، لأن الحكم الحقيقي هو الذي لا يُعرف إلا بوحيٍ قطعي الدلالة والثبوت، وما عداه يدخل في مساحات الاجتهاد.
وقد تجلّى هذا في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم حين رفض اعتبار اجتهاد الصحابي حكماً إلهياً، وفي مواقف أخرى مثل قصة تأمير أسامة بن زيد، وقوله: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل…»، وفي اختلاف الصحابة حول أسرى بدر، وفي صلح الحديبية الذي جاء تقديراً لمصلحة عليا لا تنطلق من وحي مباشر، وفي تقسيم غنائم حنين بدافع سياسي واجتماعي.
بل إن الخلفاء الراشدين أنفسهم اجتهدوا في تعطيل بعض الأحكام أو تغيير آليات تطبيقها مراعاة لظروف الأمة، ما يدل على أن مقاصد الشريعة في الميزان الأعلى، وأن النصوص الظنية تُنزل وفق المصلحة.
هذا الفهم العميق هو ما صاغه أبو الحسن الندوي في منهجه التحليلي حين رأى أن الوحي يقدم المبادئ الكبرى، والقيم الكلية مثل العدل، وصيانة الحقوق، وحماية المجتمع، بينما تترك تفاصيل السياسة وإدارة الواقع مجالاً للاجتهاد الإنساني. فالروح ترسم الأفق، والإنسان يملأ الفراغ التنفيذي وفق ظروف الزمان والمكان. وبذلك لا تُرفع القرارات السياسية إلى مرتبة العصمة، ولا تُنسب إلى الله إلا الأحكام القطعية التي لا تتبدّل.
إن إدراك الفارق بين حكم الله القطعي وحكم المجتهد الظني ضرورة معاصرة لفهم السياسة الشرعية وتحصين الدين من التوظيف السياسي.
فإلحاق بينهما يولّد التطرف ويغلق باب الحوار، ويمنح الجماعات السياسية “قداسة زائفة”.
أما التمييز الواضح فيعيد السياسة إلى مجالها الطبيعي: قرارات بشرية قابلة للنقد والمساءلة، تستلهم المقاصد الكبرى دون أن تدّعي امتلاك الإرادة الإلهية. وهكذا يصبح الاجتهاد ممارسة مسؤولة، ويستعيد الدين دوره في توجيه القيم دون أن يتحوّل إلى أداة صراع أو ساحة للمزايدة.
إن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بأن يُنزِّل الأسرى على حكمه هو مع التنبيه على احتمال الخطأ «فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله فيهم أم لا» يرسخ مبدأ عدم قداسة القرار السياسي.
يظهر التوجيه النبوي القائل بعدم إنزال الخصوم على حكم الله والاكتفاء بما يراه القائد من اجتهاد بشري رسالة عميقة في ضبط العلاقة بين الوحي والعمل السياسي، إذ يكشف أن القرارات المتخذة في الشأن العام ليست أحكاماً نهائية منزلة، بل اختيارات بشرية قابلة للمراجعة والنقد.
فإن كان ما يتحمل مسؤولية قراره أمام الله وأمام التاريخ بما يعني أن السلطة ليست تفويضاً مطلقاً، ولا مسوغاً لاحتكار الصواب أو الادعاء بأن الرأي المعتمد يمثل الإرادة الإلهية.
ومن هذا المنطلق انتقلت المسؤولية الفردية في القرار السياسي إلى نزع صبغة القداسة، وإعادته إلى مجاله الطبيعي بوصفه اجتهاداً بشرياً يخضع لموازين المصلحة وقد يصيب أو يخطئ.
هذا التوجيه يرتبط كذلك بطبيعة السياسة نفسها، فهي مجال ظني متغير لا يقبل القطع ولا يُعلى فيه على امتلاك الحقيقة النهائية.
ولذلك جاء التحذير النبوي من نسبة لاجتهاد البشري إلى الله حتى لا تتحول المواقف السياسية إلى أحكام مقدسة أو أدوات لإسكات النقد والمحاسبة.
فمادام ما يقرره النبي فيما لا يأتيه حكم الله فيه، فإن الباب يفتح أمام الوعي بأن القرارات السياسية مهما بنيت تبقى ضمن دائرة الظن، وأن صوابها يحتاج إلى نقاش وتقدير وتقييم مستمر.
وتنعكس هذه الدلالات على بنية التفكير السياسي في الإسلام، إذ يدعو الحديث إلى تحرير العقل من وهم امتلاك الحقيقة في الشؤون المتغيرة، ويمنع تحويل الأداء البشرية إلى مسلمات تُلزم الآخرين باسم الدين.
فهذا التوجيه يبعد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فالوحي يضع المعايير والقيم العامة، أما تنزيلها على الواقع المتغير فهو عمل بشري اجتهادي لا ينبغي تضخيمه ولا نسبته إلى الله على سبيل القطع. وبهذا يتحرر العقل المسلم من ضغط القداسة التي قد تولد الاستبداد أو تمنح الرأي الواحد سلطة مطلقة، كما يعيد للتجربة السياسية إنسانيتها القائمة على الحوار والمراجعة والتعلم من الخطأ.
وبذلك تكتمل الدلالات الثلاث: المسؤولية الفردية، وظنية الاجتهاد السياسي، والتحرر من ادعاء الحقيقة المطلقة.
ليمنح هذا التوجيه النبوي عمقه الحركي في الواقع المعاصر، فهو يحرر السياسة من التقديس، ويمنح المجتمع مساحة واسعة للنقد والمحاسبة، ويضمن بقاء القرار السياسي عملاً بشرياً منفتحاً على التصويب والتطوير.
ظنية الاجتهاد السياسي وفتح باب النقد
تقوم الفكرة المركزية لظنية الاجتهاد السياسي على اعتبار السياسة فعلاً بشرياً متغيراً محكوماً بحركة الواقع وقابلية المصالح، لا مجال فيه للقطع ولا لادعاء امتلاك الحقيقة النهائية. فكل قرار سياسي مهما بدا محكماً أو راجحاً يظل في نطاق الظن والاحتمال، وهو ما يمنع تحوله إلى مقدس ويجعل النقد والمحاسبة ضرورة لا غنى عنها لضبط الممارسة السياسية.
وقد أدرك علماء الفكر الإسلامي هذا البعد المتغير للسياسة منذ القرون الأولى. فالإمام الشافعي يوضح بين القطعي الذي لا يقبل الجدل، والظني الذي هو مجال الاجتهاد، والمقاصد التي جوهرها موازنة وترتيب أولويات وتقدير مصالح ومفاسد، وهي عناصر بطبيعتها نسبية ومتغيرة بتغير الزمان والمكان.
لذلك قال الغزالي والجويني إن معظم مسائل الخلافة والحكم تدور في إطار الظن المعرفي.
ومن هنا تأتي خطورة تصوير القرار السياسي على أنه قرار مقدس. فقد جرى توظيفه في صراعات سياسية، فصار النقد يُفسر على أنه تعد على القرار “الديني”، حتى أدى ذلك إلى تكريس الطاعة العمياء وفتح الباب أمام الاستبداد.
وقد تناول مفكرون معاصرون هذا الإشكال، منهم محمد سعيد العشماوي الذي أكد ضرورة التمييز بين الشريعة بوصفها مبادئ عامة، والتشريع أو السياسة بوصفهما مجالات بشرية قابلة للنقد والمراجعة.
إن استحضار ظنية الاجتهاد السياسي ليس تنظيراً فلسفياً فقط، بل هو مشروع لإعادة الاعتبار للإنسان، وتحويل القرار السياسي من فعل فوقي مطلق إلى عملية بشرية مفتوحة للنقاش والتطوير. إنها دعوة لاعتماد ثقافة سياسية قائمة على تواضع المعرفة، وتقدير الاختلاف، وإعلاء قيم النقد والمحاسبة.
والموازنة أما في الغالي فيصوّر قراراً إلهاً مطلقاً يُعامل بمنطق العصمة، مما يؤدي إلى الاستبداد والجمود ومنع النقد.
إن ترسيخ الظنية يفتح الباب لتعدد الآراء، ويجعل القرار السياسي قابلاً للتصحيح، ويمنح المجال العام دينامية صحية، بينما يؤدي ادعاء القداسة إلى إغلاق الأفق وإسكات المخالفين.
إن استحضار ظنية الاجتهاد السياسي ليس مجرد تنظير فلسفي أو فقهي، بل هو مشروع لإعادة الاعتبار للإنسان في المجال السياسي، وتحويل القرار من فعل فوقي مطلق يُلبّس بالقداسة إلى عملية بشرية مفتوحة للنقاش والتطوير. وهي دعوة لبناء ثقافة سياسية قائمة على التواضع المعرفي، وتقدير الاختلاف، وإعلاء قيم النقد والمحاسبة، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الممارسات السياسية السليمة.
فعندما يتحرر القرار السياسي من القداسة المزعومة، يصبح المجال العام أوسع وحرّاً ومتوازناً، ويستعيد المجتمع قدرته على المشاركة الفاعلة في توجيه مساره.
- الخاتمة والاستنتاجات
بعد حديث «لا تُنزِّلوهم على حكم الله» نصاً محورياً في الفقه السياسي الإسلامي، حيث يقدم إطاراً منهجياً لضبط العلاقة بين الوحي والاجتهاد.
وتخلص الدراسة إلى الاستنتاجات الرئيسية:
- القرار السياسي اجتهاد بشري ظني:
لا يجوز لأي سلطة سياسية أو حركة أن تضفي صفة القطع أو القداسة على قراراتها، حتى لو كانت مستنبطة من نصوص شرعية. - الحديث أساس لنبذ الغلو:
يمثل الحديث أداة نقدية قوية ضد خطاب التعصب الذي ينسب الاجتهادات البشرية إلى الذات الإلهية، وهو ما يعد أصل الغلو والاستبداد باسم الدين. - ترسيخ المسؤولية المدنية:
يلقي الحديث المسؤولية كاملة على عاتق القائد، ويرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة في الشأن العام.
إن إعادة استحضار هذه التوجيهات النبوية وتحليلها في سياق النقاشات المعاصرة حول الطرق المثلى للسياسة الشرعية يمثل شرطاً أساسياً لتهذيب الخطاب الديني، وتجنب المجتمعات مظاهر الغلو والاستبداد، واستعادة العقل السياسي بوصفه مجالاً بشرياً قابلاً للخطأ وللمراجعة والتطوير.